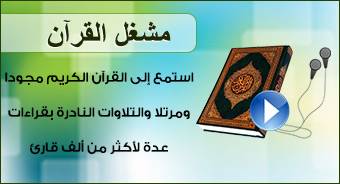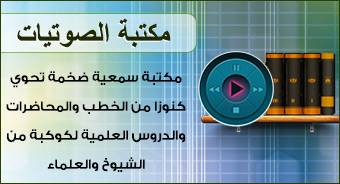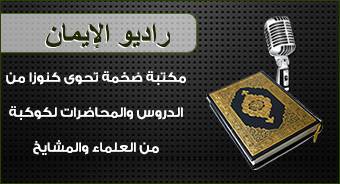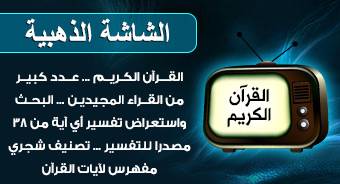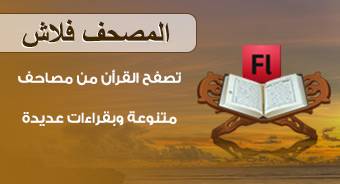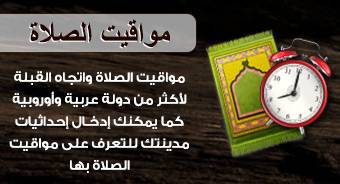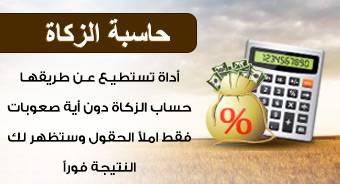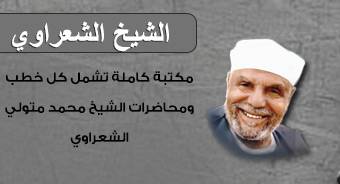|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة
قال محمد بن رشد: إنما قال: إذا كانوا لأم أنه يعتق الأصغر، ومن الأوسط ثلثاه، ومن الأكبر ثلثه؛ لأن الصغير حر على كل حال، والأوسط يجب له العتق في حالين، والرق في حال، والكبير يجب له الرق في حالين، والعتق في حال. وقوله: وقد قيل إنه يقرع بينهم وإن كانوا لأم، إنما معناه أنه يقرع بين الأكبر والأوسط، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون أصابه العتق، وأن يكون لم يصبه؛ وأما الأصغر فهو حر على كل حال، لا يصح أن يختلف فيه، وإن كان ظاهر الرواية خلاف ذلك، فتأول على هذا وهو تأويل سائغ، لأن الابنين جماعة، فيحتمل أن يصرف ضمير الجمع في قوله بينهم؛ إليهما دون الثالث، ويأتي على ما قال بعد هذا في الذي قال عند موته: إن فلانة جاريته ولدت منه، أن الأكبر والأوسط يعتقان جميعا أيضا من ناحية الشك، إذ لا يصح للورثة تملك واحد منهما وهو لا يعلم إن كان عبدا أو حرا، وهو أظهر- والله أعلم- من أن يقرع بينهما، لأن القرعة لا ترفع الشك، وهي في القياس غرر، فلا ينبغي أن تستعمل إلا حيث وردت في السنة، ومن أن يعتق من الأكبر ثلثه، ومن الأوسط ثلثاه، لأنا نحيط علما أن الميت لم يرد ذلك، إذ لا يحتمله لفظه، فهذا القول أضعف الأقوال، ويتخرج في المسألة قول رابع وهو أن يكونا جميعا عبدين، لاحتمال أن يكون الميت لم يرد واحدا منهما وإنما أراد الأصغر، فلا يعتق واحد منهما إلا بيقين على القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين. وقوله: إنه لا يثبت نسبه صحيح لا اختلاف فيه، إذ لا يصح أن يحكم بثبوته لواحد منهم بشك، وأما قوله: إنه لا يرثه واحد منهم، ففيه نظر؛ والذي يوجبه النظر في ذلك عندي أن يكون حظهم من الميراث بينهم على القول بأنهم يعتقون جميعا على ما قاله بعد هذا في المسألة التي ذكرناها وهو الصحيح، إذ قد صح الميراث لأحدهم ولا يدري لمن هو منهم، فإن تداعوا فيه فادعاه كل واحد منهم، قسم بينهم بعد أيمانهم، إن حلفوا جميعا، وكذلك إن نكلوا جميعا، وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم عن اليمين، كان الميراث للحالف منهم دون الناكل؛ وكذلك أن لو قالوا لا علم لنا، كان الميراث بينهم بعد أن يحلف كل واحد منهم أنه لم يعلم من أراد الميت منهم على الاختلاف في لحوق يمين التهمة، لأنها يمين التهمة في هذا الموضع؛ وإن أعتق بعضهم، كان لمن أعتق حظه من الميراث، ويوقف حظ من لم يعتق؛ فإن عتق أخذه، وإن مات قبل أن يعتق رد على الورثة؛ وأما إذا كانوا مفترقين، فهو بمنزلة إذا قال: أحد عبيدي حر، ثم مات قبل أن يسأل أيهم أراد، لأن معنى قوله في الرواية فغفل عن ذلك حتى مات، أي غفل أن يسأل أيهم أراد أنه ابنه حتى مات، وفي ذلك ستة أقوال، أحدها: أنه يقرع بينهم فما خرج السهم عليه منهم عتق. والثاني: أن العتق يجري فيهم فيعتق ثلث كل واحد منهم إن كانوا ثلاثة، وربعه إن كانوا أربعة، أو كانوا أكثر من ذلك على هذا القياس. والثالث: أن الورثة ينزلون فيهم بمنزلة الميت يعتقون منهم أيهم شاءوا. والرابع: أنهم يعتق ثلثهم بالسهم إن كانوا ثلاثة، وربعهم بالسهم إن كانوا أربعة، وكذلك إن كانوا أقل أو أكثر. والخامس: أن الورثة يخيرون إن اتفقوا، فإن اختلفوا أقرع بينهم. والسادس: أن الورثة يخيرون، فإن اختلفوا جرى العتق في عددهم، والثلاثة الأقوال الأول لابن القاسم، والرابع لمالك، والخامس والسادس لسحنون، وكلها في كتاب العتق من العتبية، وفي المسألة قول سابع أنهم يعتقون كلهم من أجل الشك، إذ لا يسوغ للورثة تملك واحد منهم، لاحتمال أن يكون هو الذي عنى الميت على ما ذكرناه، ويؤيد هذا القول ما روي أن عبد الله بن عمر قال: يفرق بالشك، ولا يجمع بالشك؛ ويتخرج في المسألة قول ثامن وهو أن يوقف الورثة عن جميعهم إلا أن يموت واحد منهم أو يعتقوه، فلا يحكم عليهم في الباقين بعتق، وإنما يؤمرون به ولا يجبرون عليه؛ وهذا على قياس القول بأن الشك لا يؤثر في اليقين، ولا يثبت نسب واحد منهم، ويكون الحكم في الميراث على قياس ما تقدم، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة فيها ثلاثة أقوال، أحدها: أن السدس الذي برئت به الأم لإقرارها بالأخ يكون له، روي هذا القول عن مالك وعليه الجماعة من أصحابه، وهو قول جميع الفراض، وأظهر الأقوال؛ لأن المقر به يقول قد جحدني الأخ الثلث، فكيف يوقف لي شيء من السدس الذي برئت به الأم، وهو اختيار ابن المواز. والقول الثاني: أن السدس الذي برئت به الأم يكون بين المستلحق والأخ الثابت النسب، قال أصبغ: لأنه يقول ما برئت به الأم فأنا أحق به، إذ لا وارث معي؛ ويقول المستلحق: بل هو لي فيقسم بينهما، ووجه ثان: أن الأم لم تحجب عن الثلث إلى السدس إلا لهما جميعا، فوجب أن يكون بينهما. والقول الثالث: قول سحنون هذا أن السدس الذي برئت به الأم يكون نصفه للأخ المستلحق، والنصف الآخر موقوفا لا يأخذه الأخ، إلا أن يقر بما أقرت به الأم، فيأخذه ويرفع نصف ما بيده- وهو أضعف الأقوال، لأنه إذا كان لا يأخذ نصف السدس إلا أن يعطي أكثر منه، فلا معنى لتوقيفه، ولا يشبه مسألة الصداق التي نظرها بها، لأن المرأة أنكرت ما أقر لها به الزوج، فوجب أن يكون لمن رجع منهما- أولا إلى تصديق صاحبه- على قول سحنون في هذه المسألة- أنه يقال للمرأة قد أقر لك بجميع الصداق، فإن أقرت بالوطء فخذيه، وإلا لم يكن لك إلا نصف الصداق. وقوله هذا يبين ما لابن القاسم في كتاب إرخاء الستور من المدونة، لأن له في كتاب الرهون مثله، وهو قول أشهب في كتاب إرضاء الستور من المدونة، ولسحنون بعد هذا في هذه النوازل، خلاف قوله هذا إن لها أن تأخذ ما أقر لها به- وإن كانت مقيمة على الإنكار، وقيل: إنه لا يحكم لها بأخذ ما أقر لها به- وإن رجعت إلى قوله وصدقته، إلا أن يشاء أن يدفع ذلك إليها- قاله ابن القاسم في سماع عيسى من كتاب النكاح ومن كتاب الدعوى والصلح، ولا يدخل شيء من هذا في مسألتنا، لأن الأخ لم ينكر إقرار الأم به، ولو أنكر ذلك، لكان الحكم فيه كالحكم في مسألة الصداق وما يشبههما من المسائل لكون السدس الذي برئت به الأم موقوفا يأخذه من رجع منهما- أولا إلى تصديق صاحبه، ويدخل في ذلك الاختلاف الذي ذكرناه، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه في المذهب إذ لا وارث له غير الذي أقر به، والمخالف في ذلك الشافعي يقول: لا يلزمه أن يعطيه شيئا بحكم، إذ لم يثبت النسب بقوله- وهو بعيد، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة تشتمل على أربع مسائل، وقوله في أول مسألة منها يكون للمقر له في سهم المقر ما كان يصير له في سهمه، هو المشهور في المذهب المعلوم من قول مالك وأصحابه وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى ما في ذلك من الاختلاف، وتحصيل القول فيه، فلا معنى لإعادته. وقوله في المسألة الثانية قيل: فإن مات المقر له قال: يرثانه جميعا المقر به والمنكر له، يرد قوله في المسألة التي قبل هذا في الصداق أن المرأة لا تأخذ جميعه إلا أن تقر بما أقر به الزوج من الوطء، وقد مضى ذكر الاختلاف في ذلك، فلا معنى لإعادته. وقوله: وهو بمنزلة رجل قال: مات أخي وترك ألف دينار وهو أخوك أيضا أن الألف بينهما، تنظير غير صحيح، لأن الألف لا تكون بينهما إلا أن يقر بأنه أخوه؛ وأما إن أنكر فهي مسألتنا بعينها، فلا وجه للاحتجاج بها عليها. وقوله في المسألة الثالثة. قيل له فإن مات المقر، فهل يرثانه جميعا المقر له والمنكر له، قال: لا يرثه المقر له وإنما يرثه أخوه ومن كان من نسبه، صحيح لا اختلاف فيه، لأن نسب المقر به لا يثبت بإقرار المقر به، إلا أن يكون الذي أقر به رجلين عدلين، فلا يرث المقر به بإقراره به بإجماع، وقوله: وهو بمنزلة رجل كان لرجل عليه بينة أنه أعتقه وأقر لرجل أنه أخوه وأنه إن مات ورثه مولاه الذي عيه البينة، ولا يرثه الذي أقر، تنظير غير صحيح، لأنها هي المسألة بعينها، فلا معنى للاحتجاج بها عليها. وقوله في المسألة الرابعة: وإن مات ولا نسب له ورثه المقر له، خلاف المشهور من مذهبه في أن بيت المال مثل النسب القائم، فلا يرث المقر به المقر وإن لم يكن له وارث معروف النسب، مثل قول الجماعة أن المقر به يرث المقر إذا لم يكن له وارث معروف بنسب ولا ولاء، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأن استلحاقه لابنة الميت الذي لاعن به استلحاق منه لابنته، فهي تلحق بجدها، وهو مثل ما في المدونة من أن الملاعن له أن يستلحق ولده الذي لاعن به بعد أن مات، ولا يتهم على أنه إنما استلحقه ليرثه إذا كان له ولد، فكما لا يتهم مع الولد وإن كان يرث معه السدس، فكذلك لا يتهم مع الابنة وإن كان يرث معها النصف؛ إذ قد يكون مال الذي ترك الولد الذكر كثيرا، فيكون السدس منه أكثر من نصف مال الذي ترك الابنة، وكذلك لو ترك الولد الذي لاعن به أو الابنة التي لاعن بها ولد ولد وإن سفل فاستلحقه، بأن يقول والد هذا ولدي وأنا جده، أو استلحق ولده الذي لاعن به، أو ابنته التي لاعن بها، لأن استلحاقه لولده استلحاق لولد ولده، واستلحاقه لولد ولده على الوجه التي ذكرت لك استلحاق لولده، وليس له أن يلحق بولده ولدا هو له منكر؛ وإذا استلحق واحدا منهما، حد على كل حال، وقيل إنما يحد إذا كان لعانه على نفي الحمل، وأما إذا كان لعانه على الرؤية أو على نفي الولد أو على نفي الولد مع الرؤية فلا حد عليه، لأن لعان الرؤية باق وإن استلحق الولد، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنه إذا أقر لورثته بما شهدت به البينة، كان ذلك بمنزلة إذا شهدت البينة أنه قال إحدى هؤلاء الثلاث ابنتي ولم يسمها لهم، فالشهادة جائزة باتفاق. وقوله في هذه المسألة إنهن يعتقن كلهن، خلاف قوله قبل هذا في هذه النوازل في الذي قال في مرضه في عبيد له ثلاثة: أحد هؤلاء ابني ولم يسأل أيهم أراد حتى مات؛ وقد مضى القول على ذلك مستوفى، فلا معنى لإعادته، وأما إذا جحدوا، فقوله: إنه لا عتق لواحدة منهن حين تعلم البينة أيتهن هي، هو المشهور في المذهب: أن الشهادة باطلة إذا كان الميت قد سماها لهم، أو عينها فنسي الشهود اسمها، أو لم يثبتوا عينها، وشكوا في ذلك، وقد قيل: إن الشهادة جائزة، ويكون الحكم في ذلك بمنزلة إذا لم يسمها لهم ولا عينها، وهو قوله في أصل الأسدية في مسألة كتاب الإيمان بالطلاق، لأنه وقع فيها فشك الشهود ولم يعلموا أيتهن المطلقة التي قد دخل بها، أو التي لم يدخل بها، وقد فرق في ذلك بين أن تكون الشهادة في الصحة أو في المرض؛ فيتحصل في ذلك ثلاثة أقوال، أحدها: أن الشهادة جائزة في الصحة والمرض، والثاني: أنها لا تجوز في الصحة وإلا في المرض. والثالث: أنها تجوز في المرض ولا تجوز في الصحة، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال، وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق ولدها، بخلاف الأب، لأن الولد إنما ينتسب إلى أبيه لا إلى أمه، والأصل في ذلك قول الله عز وجل: {ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ} [الأحزاب: 5] إلى قوله: {وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]، ولولا ما أحكم الشرع من هذا، لكان نسبة الرجل إلى أمه أولى من نسبته إلى أبيه، لأنها أخص به من أبيه، لأنهما اشتركا بالماء، واختصت هي بالحمل والوضع دونه، وهذا أصل في أن الزرع في المزارعة الفاسدة لصاحب البذر، لا لصاحب الأرض، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: قد تقدم القول قبل هذا على هذه المسألة مستوفى، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: قوله وأسلمت الأم والولد، ثم مات أحد الولدين- يريد ولم يسلم الأب، أو بعد أن مات، لأنه لو مات أحد الولدين، والأب حي قد أسلم- لكان الميراث له، لأن الأب يحجب الإخوة كلهم؛ ولو مات الأب وقد أسلم، لكان الميراث بين ابنيه وابنته أمهما- أخماسا؛ وقد اختلف إذا مات أحد الولدين والأب على مجوسيته، أو بعد أن مات، فقال سحنون في هذه الرواية للأم السدس، لأنها أم وأخت؛ فكان الميت قد ترك أما وأختا وأخا، فرأى لها السدس لأنها حجبت نفسها عن الثلث إلى السدس، وأهل الفرائض يعطون في هذه الفريضة للأم الثلث- وهو أظهر، لأنها إنما ورثت على أنها أم، ولم تورث على أنها أخت وأم، فألغي كونها أختا مع كونها أما، ويلزم سحنون على قياس قوله إذا لم يلغ كونها أختا مع كونها أما، حجبها نفسها عن الثلث إلى السدس- أن يورثها على أنها أخت، وعلى أنها أم، فيعطيها السدس من أجل أنها أم، ويعطيها الثلث مع الأخ من أجل أنها أخت- وهذا مما لم يقولوه أنها تورث من وجهين، وإنما الذي قالوه إنها تورث بالأقوى سببا، وإن كان حظها به أقل على ما قاله سحنون في هذه المسألة؛ وأما على ما قاله أهل الفرائض فيها فيستوي حظها على أنها أم، وعلى أنها أخت؛ لأن للأم مع الأخ الواحد الثلث، وللأخت معه الثلث أيضا؛ ولو كان المجوسي لما تزوج ابنته ولد له منها ابن، ثم مات الابن بعد الأب، أو قبل أن يسلم- فترك أمه وهي أخته أيضا، لورثت الثلث على أنها أم، ولم تورث النصف على أنها أخت- وإن كان حظها على أنها أخت أكثر، لأنه إنما يراعى قوة سببها لا كثرة حظها، والأم أقوى سببا من الأخت؛ لأنها ترث مع الأب والابن، ولا ترث الأخت مع واحد منهما شيئا، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال أنه لا يتهم في استلحاق الولد إذا كان له ولد وإن كان قد جني عليه جناية فمات منها يجب له باستلحاقه حظه من ديته، إن كان ابنه حرا، أو جميع الدية إن كان عبدا، لأن استلحاقه لولده بعد موته، استلحاق لولد ولده، واستلحاق النسب يرفع التهمة في الميراث على ما قاله في استلحاق الولد الذي لاعن به بعد أن جني عليه جناية مات منها؛ لأن استلحاق ولد الولد يرفع التهمة عنه في ميراث ولده إن كان له مال، وفي ديته إن كان قتل خطأ أو عمدا على القول بأنه مخير في العمد بين أن يقتل أو يأخذ الدية؛ وقد مضى قبل هذا في هذه النوازل في استلحاق الملاعن ولده بعد موته ما فيه بيان هذه المسألة؛ وأما إذا استلحق الولد الذي باع مع أمه وقد كان ولد عنده ولم يكن له نسب وهو حي، فلا اختلاف في أنه يلحق به، ويفسخ البيع فيه؛ ويرد إليه ولدا وأمه أم ولد- وإن كان الولد قد أعتق وينتقض العتق، وقيل إنه لا ينتقض، إلا أن يتهم في الجارية بميل إليها، أو زيادة في حالها، أو يكون معدما؛ فيمضي بما ينوبها من الثمن، ويرد الابن بما ينوبه منه، ويتبع به دينار في ذمته إن لم يكن له مال، وقيل: إنها ترد مع ابنها وإن اتهم فيها، إلا أن يكون معدما؛ وقيل: إنها ترد مع ابنها، وإن كان معدما، ويتبع بالثمن دينا في ذمته، إلا أن يتهم فيها، وكذلك إن باعها وهي حامل فولدت عند المشتري إلى ما يلحق في مثله الأنساب، ولم يطأ المشتري ولا زوج؛ وإذا رد الولد دون الأم لاتهامه فيه، أو لعدمه على الاختلاف الذي ذكرناه في ذلك، فيكون على البائع في الولد قيمته يوم يرد إليه، وقد مضى القول على هذا مستوفى في سماع يحيى من كتاب الاستبراء، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول عليها مستوفى، فلا معنى لإعادته هنا مرة أخرى، وبالله التوفيق.
وسئل ابن القاسم عن أربع بنات استلحقت إحداهن أخا، أو استلحقت أخا وأختا؛ قال: إن استلحقت أخا لم يكن عليها غرم، لأنه لو ثبت نسبه، كان حقه فيما صار في يد العصبة؛ ولو استلحقت أخا وأختا نظر إلى أصل الفريضة لو كان الأخ معهم فأكمل لها، ثم نظر إلى ما فضل في يديها فرددته، فكان بين الأخ والأخت على فرائض الله؛ لأن الأخ لو كان لا يدخل مع الأخت، ثم كانت هي وارثة وحدها فكان لها النصف فأقرت بأخ وأخت؛ لا ينبغي أن يكون فضل ما تفضله أن لو ثبت نسبها للأخت دون الأخ حتى يستتم الثلثان، فليس هو كذلك؛ ولكن الإقرار بينهما جميعا يقتسمونه على فرائض الله؛ وأصل هذا أن ينظر ما لو ثبت نسبه ببينة فكأن يكون بين جميع من ثبت له البينة على فرائض الله، وكذلك كل من أقر لهم في فضل ما في يديه يرجع عليهم على فرائض الله، وكل من أقر بشيء يكون ما أقر له ليس في يديه فضل أن لو ثبت نسبه فلا ينقص من حقه شيء، ويكون حقه فيما ورث العصبة من ذلك؛ هذا ما سمعت، وهو مما لا اختلاف فيه؛ وقال ابن كنانة: ذلك للأخت دون الأخ، لأن حق الأخ فيما بين العصبة لم يصر إليها منه شيء؛ قال: ولو أنها إذا استلحقته كان معها قبل ذلك أخ قد كان ورث معها، ثم استلحقت هذا بعد؛ فإنه إذًا يأخذ مما بيدها قدر ما ينوبه، لأن له في يديها حقا قل ذلك أو كثر، من أجل الأخ الذي معها قبل ذلك. قال محمد بن رشد: قوله في الأربع بنات إذا استلحقت إحداهن أخا لم يكن عليها غرم؛ لأنه لو ثبت نسبه كان حقه فيما صار في يدي العصبة هو المشهور في المذهب، وقد مضى في رسم العتق من سماع عيسى ذكر الاختلاف في ذلك، ووجه القول فيه؛ فقوله في آخر المسألة في هذا: هذا ما سمعت، وهو مما لا اختلاف فيه، ليس بصحيح، لما قد ذكرناه من الاختلاف في ذلك، وأما قوله ولو استلحقت أخا وأختا نظر إلى أصل الفريضة لو كان الأخ معهم- يريد لو كان الأخ والأخت معهم، لأنها إنما أقرت بهما جميعا، فما فضل في يديهما مما يجب لها على الإنكار لهما على ما يجب لها على الإقرار بهما، كان بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا قول ابن القاسم- وهو الصحيح في النظر، بدليل ما احتج به في الرواية، وظاهر قول ابن كنانة أن الفضل الذي يراه ابن القاسم بين الأخ والأخت، هو الذي يراه هو للأخت دون الأخ، وذلك مما لا يصح أن يحمل على ظاهره، وإنما معناه أن ما فضل بيدها على الإنكار لهما جميعا على ما يجب لها على الإقرار بها وحدها يكون لها؛ فمحصول قوله أن إقرار الواحدة من البنات الأربع بأخ وأخت، كإقرارها بأخت لا أكثر سواء، والذي في الواضحة أيضا في هذا مشكل، وهذا بيانه، إذ لا يصح في النظر خلافه؛ وقول ابن كنانة هذا خلاف ما حكيناه عنه في رسم العتق من سماع عيسى من أن المقر به من الورثة يرجع على من أقر به منهم أو على من أنكره، على التفسير الذي ذكرناه هنالك، فلا معنى لإعادته، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة، ورأيت لابن دحون أنه قال فيها: والجارية لها مملوكة، لأنها لما أقرت أنها أباحتها لزوجها فهو زنى يدرأ فيه الحد بهذه الشبهة؛ ولو كان معها شاهدان بإقرار الزوج على ذلك، لأخذت قيمتها من ماله، وعتقت عن الميت، لأنها أم ولده؛ فإذا لم يكن إلا دعوى الزوجة، فالجارية باقية على ملكها، والابن حر، بإقرارها أنها أباحتها لزوجها وتدفع ما أقرت له به وهو الثمن وليس ذلك عندي بصحيح، بل قول ابن القاسم أنها تعتق هي وولدها عليها هو الصحيح، ولا تقوم عليه في ماله، إذ لا يعرف ذلك إلا من قولها، فهي مدعية في القيمة، لإقرارها أن الواجب أن تعتق عليه، ويؤخذ منه لها القيمة، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذا كما قال: إن النسب يثبت بإقرارهما جميعا إذا كانا عدلين؛ لأن النسب يثبت بشهادة شاهدين، وشهادتهما جائزة، إذ لا تهمة عليهما فيها، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: قوله إن المولى عليه إذا استلحق أخا لا يلزمه في ماله ما يلزم غيره، ظاهره مثل المشهور من قول مالك أن المولى عليه لا تجوز أفعاله وإن كان حسن النظر، إذا أطلق القول ولم يقيد ذلك بشرط أن يكون سيئ النظر، خلاف المشهور من قوله أن أفعاله جائزة إذا كان حسن النظر لنفسه- وإن كان مولى عليه، وبالله التوفيق.
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة على معنى ما في المدونة، وما تقدم في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من هذا الكتاب، وقد مضى من الكلام عليه- ما فيه بيان لهذه المسألة؛ ورأيت لبعض أهل النظر أنه قال: مساواة أصبغ في هذه الرواية بين أن يقول فلان وارثي، أو فلان أخي، أو فلان ابن عمي، خلاف قول ابن القاسم في المدونة، إذ لم يجز شهادة الشهود للرجل أن فلانا مولاه دون تفسير حتى يقولوا مولاه أعتقه؛ وليس مذهب ابن القاسم أن شهادتهم لا تجوز بحال حتى يقولوا أعتقه، وإنما معناه أنها لا تجوز إذا سئلوا فأبوا أن يفسروا؛ فالواجب عنده أن يسألوا عن تفسير ما به شهدوا، فإن فات ولم يسألوا حتى فات سؤالهم، جازت الشهادة، بدليل قوله وأقر الميت أن هذا مولاه، أو شهدا على شهادة أحد أن هذا مولاه؛ وأما أن يقولا هو مولاه ولا يشهدان على عتقه، ولا على إقراره، ولا على شهادة أحد، فلا أرى ذلك شيئا؛ وهو قول أشهب أنه إن لم يقدر على كشفهم حتى ماتوا جازت الشهادة، وقضى بها في المال وغيره، وسحنون لا يجوز الإقرار بحال، لأن بيت المال عنده كالنسب القائم. والذي أقول به في هذه المسألة على مذهب ابن القاسم إذا قال: فلان وارثي فلم يفسر شيئا حتى مات، أن يكون له جميع الميراث، لأن الظاهر من قوله فلان وارثي، أنه المحيط بميراثه؛ وهذا فيمن يظن به أنه لا يخفى عليه من يرثه ممن لا يرثه؛ وأما الجاهل الذي لا يعلم من يرثه ممن لا يرثه، فلا يرثه بقوله فلان وارثي حتى يقول هو ابن عمي أو ابن ابن عمي، أو ابن عم عمي، أو ابن ابن عم عمي، أو مولاي أعتقني، أو أعتق أبي، أو أعتق من أعتقني، أو من أعتق أبي، أو ولد من أعتقني، أو من أعتق أبي، أو من أعتق من أعتقني، وما أشبه ذلك؛ وكذلك إذا قال: فلان أخي قاصدا بذلك إلى الإشهاد بالميراث، مثل أن يقول: أشهدكم أن هذا أخي يرثني، إن مت، ومثل أن يقال له: هل لك وارث فيقول: نعم هذا أخي، وما أشبه ذلك، وأما إن قال على غير سبب: هذا أخي، أو فلان أخي- ولم يزد على ذلك، فلا يرث من ماله إلا السدس، لاحتمال أن يكون أخاه لأمه، ولو لم يقل هذا أخي، ولا فلان أخي؛ وإنما سمعوه يقول: يا أخي يا أخي، لم يجب له بذلك ميراث، لأن الرجل قد يقول أخي، أخي- للرجل الذي لا قرابة بينه وبينه- يقر به بذلك إلا أن تطول المدة السنين بأن يدعو كل واحد منهما صاحبه باسم الأخوة أو العمومة، فيكون ذلك حيازة للنسب، ويتوارثان بذلك، ويشبه- على قول سحنون الذي تقدم له في نوازله- ألا يكون له الميراث بقوله فلان أخي، أو فلان وارثي- حتى يفسر، إذ قد قال- وهو المشهور من مذهبه- أنه لا ميراث له وإن فسر، لأن بيت المال كالنسب القائم، وبالله التوفيق.
|